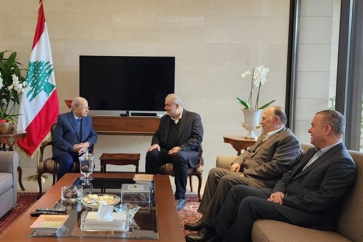أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، أن “لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به. أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعدما قضى على الإرهابيين، سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية، واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ في الاعتبار مقررات مؤتمر “سيدر”.
وأشار الى أن “أزمات الجوار لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجه. فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين، ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمل هذا العبء غير ممكن”.
اضاف: اؤكد مجددا حق عودة النازحين ورفض اي مماطلة او مقايضة في هذا الملف ونرفض مشروع التوطين سواء لنازح أو للاجئ.
وسأل الرئيس عون: هل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الانروا او الهدف من تعطيل دورها التمهيد لاسقاط صفة لاجئ وفرض التوطين؟ وأكد ان المقاربة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط تفتقر الى العدالة والقضية الفلسطينية خير دليل وهذا اوجد مقاومة لن تنتهي حتى احقاق الحق. واشار ان بعض الدول تمتنع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها حتى لو كانت لها صفة الالزامية والفورية.
النص الكامل للكلمة:
 السيدة الرئيسة، لقد اقترحتم موضوع المناقشة العامة “جعل الأمم المتحدة ذات أهمية لجميع الناس: قيادة عالمية ومسؤوليات مشتركة من أجل مجتمعات سلمية ومنصفة ومستدامة.” وهو اقتراح جدير بالتقدير، لأنه يعني أن الأمم المتحدة، تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويرا جديا للدور المستقبلي المأمول منها.
السيدة الرئيسة، لقد اقترحتم موضوع المناقشة العامة “جعل الأمم المتحدة ذات أهمية لجميع الناس: قيادة عالمية ومسؤوليات مشتركة من أجل مجتمعات سلمية ومنصفة ومستدامة.” وهو اقتراح جدير بالتقدير، لأنه يعني أن الأمم المتحدة، تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويرا جديا للدور المستقبلي المأمول منها.
فالأمم المتحدة، ووفقا لمقاصدها والأسس التي قامت عليها، يجب أن تكون الضمير العالمي الذي يحفظ التوازن ويمنع الاعتداء ويحقق العدالة ويحمي السلام. بينما، نجد أنه في مفاصل عدة تعذر على مجلس الأمن إقرار قرارات محقة، وأحيانا مصيرية لشعب ما، بسبب حق النقض، أو ان بعض الدول تتمنع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، وذلك من دون أي مساءلة أو محاسبة.
وإليكم بعض أمثلة من صميم معاناة منطقتنا:
إن القرار 425، الصادر في العام 1978 عن مجلس الأمن، والذي دعا اسرائيل، وبشكل فوري، الى سحب قواتها من جميع الاراضي اللبنانية لم ينفذ الا بعد 22 عاما وتحت ضغط مقاومة الشعب اللبناني.
في المقابل، نجد القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1947، والذي قضى بتقسيم فلسطين، اتخذ طابع الالزامية على الرغم من أنه ليس ملزما، ونفذ فورا. بينما القرار 194، الصادر ايضا عن الجمعية العامة في العام 1948 والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في أقرب وقت ممكن، بقي حبرا على ورق طوال سبعين عاما. وفي السياق يأتي حق النقض أو حق الاعتراض، وهو لا شك له اعتبارات عدة وأسباب موجبة في أساسه، ولكن نتائجه أثرت سلبا على الكثير من الدول والشعوب وخصوصا في منطقتنا، وحجبت عنها حقوقا بديهية.
لذلك، ولكي تكون الأمم المتحدة “قيادة عالميةـ وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازنا. ومن ناحية أخرى من الأهمية بمكان أن تكون الجمعية العامة أكثر تعبيرا عن التوجه الفعلي للمجتمع الدولي.
إن الأمم المتحدة مدعوة أيضا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم. ولبنان، الذي ساهم مساهمة بارزة في وضع “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والذي التزم به صراحة في مقدمة دستوره، يؤكد أن النظرة إلى هذا الموضوع هي نظرة إلى حرية الفرد في المجتمع، وكل اعتداء على حقوق الإنسان اليوم، في أي بلد من البلدان، إنما يؤسس لنزاعات الغد.
ونشير هنا الى أن لبنان يمضي بخطوات ثابتة في مجال تعزيز حقوق الانسان على المستويين التشريعي والتنفيذي، وقد سبق للبرلمان اللبناني أن أقر قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومن ضمنها لجنة للتحقيق في استخدام التعذيب وسوء المعاملة.
وفي سياق متصل نحن على مشارف الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية متعلقة بتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن والذي دعا الدول الأعضاء الى وضع خطط عمل بهدف تمكين المرأة من المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات والتفاوض والتصدي للنزاعات. وقد تضمنت خطة العمل اللبنانية ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار على كل المستويات وتفعيل دورها في الوقاية من النزاعات وإقرار القوانين لمنع التمييز ضد النساء ولحمايتهن من العنف والاستغلال”.
وأضاف: “نحن في لبنان نتلمس طريقنا للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بنا على مختلف الصعد؛ أمنيا، تمكن لبنان من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على تجمعات الإرهابيين في الجرود الشرقية والشمالية وفكك خلاياهم النائمة.
سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية للمرة الأولى في تاريخه مما انتج تمثيلا أكثر عدالة لجميع مكونات المجتمع اللبناني. وهو اليوم على طريق تشكيل حكومة تبعا لنتائج هذه الانتخابات.
اقتصاديا، وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية لتحقيق النهوض، تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر “سيدر”، ركائزها تفعيل القطاعات الانتاجية، وتحديث البنية التحتية، وردم الهوة بين الإيرادات والإنفاق في الميزانية.
ولكن، أزمات الجوار لا تزال تضغط علينا بثقلها وبنتائجها؛ فمع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح هربا من جحيم الحرب، تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين. ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، أمنيا، بارتفاع معدل الجريمة بنسبة تخطت 30%، واقتصاديا بارتفاع معدل البطالة الى 21% ، وديموغرافيا بارتفاع الكثافة السكانية من 400 الى 600 في الكيلومتر المربع الواحد، مضافة الى محدودية إمكاناتنا، وندرة المساعدات الدولية للبنان، تجعل الاستمرار في تحمل هذا العبء غير ممكن، خصوصا أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمنا. لذلك قلت بالعودة الآمنة في كلمتي من على هذا المنبر في العام الماضي، وميزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا الى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، باستثناء قلة منهم، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم أو لدوافع اقتصادية وهؤلاء هم الأكثرية.
وإليكم حضرة الرئيسة، والحضور الكريم هذه الخارطة الصادرة في العام 2014 عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين، UNHCR، تبين تطور أعداد النازحين المسجلين من 25 الفا في العام 2012 الى أكثر من مليون في العام 2014 أي خلال سنتين فقط، وهي خير ما يعبر عما أحاول شرحه لكم. (الخارطة مرفقة ربطا)
واشير هنا الى ان الامم المتحدة قد توقفت في العام 2014 عن احصاء النازحين، وبعد ذلك التاريخ تابع الامن العام اللبناني الاحصاءات التي دلت على ان الاعداد قد تجاوزت منذ ذلك الحين وحتى اليوم المليون ونصف المليون نازح.
وعليه، أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعا لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ. وفي هذا السياق نسجل ترحيبنا بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية”.
وتابع: “من دروس التاريخ، أن الظلم يولد الانفجار، وانتفاء العدالة والكيل بمكيالين يولدان شعورا بالنقمة ويغذيان كل نزعات التطرف وما تستولده من عنف وإرهاب.
وللأسف فإن المقاربات السياسية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لا زالت تفتقر الى العدالة، وفيها الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي تعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبنا. والقضية الفلسطينية هي خير تجسيد لهذه الصورة؛ فانعدام العدالة في معالجتها أشعل حروبا كثيرة في الشرق الأوسط وأوجد مقاومة لن تنتهي إلا بانتفاء الظلم وإحقاق الحق.
لقد صوت العالم مؤخرا، في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وعلى الرغم من نتائج التصويتين اللذين عكسا إرادة المجتمع الدولي. تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون “القومية اليهودية لدولة اسرائيل”، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر، يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين.
وكي يكتمل المشهد، أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا، التي، وبتعريفها الخاص، هي “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى وتقديم المساعدة والحماية لهم الى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم”.
فهل انتهت معاناتهم لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟”!
وقال: “هناك شعب وجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون هوية ومن دون وطن، بقرار ممن يفترض بهم ان يكونوا المدافعين عن الدول الضعيفة. فليتخيل كل منا، للحظة، ان قرارا دوليا، لا رأي له فيه، سلبه أرضه وهويته. وبينما هو يحاول التشبث بهما تتوالى عليه الضربات من كل جانب ليرفع يديه. هذه هي حال الشعب الفلسطيني اليوم، المشرد في كل أنحاء العالم، فهل نرضاها لأنفسنا ولشعوبنا؟ هل يقبل بها الضمير العالمي؟ هل هذا ما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية؟ وما الذي يضمن أن لا تواجه الشعوب الصغيرة، ومنها الشعب اللبناني، نفس المصير؟!
بالتزامن، لا تزال الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 مستمرة، برا وبحرا وجوا، على الرغم من التزام لبنان الكامل به.
يعاني عالمنا اليوم أزمة تطرف وتعصب، تتمظهر برفض الاخر المختلف، رفض ثقافته وديانته ولونه وحضارته، أي رفض وجوده بالمطلق. وهذه الأزمة مرشحة للتفاقم، ولم تعد أي دولة في منأى عنها، بكل ما تحمله من آثار مدمرة على المجتمعات والدول لأنها تفجرها من الداخل.
لقد عجزت الأمم المتحدة، وقبلها عصبة الأمم، عن منع الحروب وتحقيق السلام وإحقاق الحق، خصوصا في منطقتنا، وأحد أهم الأسباب يعود الى عدم تكوين ثقافة عالمية للسلام تقوم على معرفة الآخر المختلف وممارسة العيش معاَ.
من هنا، الحاجة ملحة الى الحوار، حوار الأديان والثقافات والأعراق، والى إنشاء مؤسسات ثقافية دولية متخصصة بنشر ثقافة الحوار والسلام.
ولبنان، بمجتمعه التعددي الذي يعيش فيه المسيحيون والمسلمون معا ويتشاركون الحكم والإدارة، وبما يختزن من خبرات أبنائه المنتشرين في كل بقاع الأرض، وبما يشكل من عصارة حضارات وثقافات عاشها على مر العصور، يعتبر نموذجيا لتأسيس أكاديمية دولية لنشر هذه القيم ، “أكاديمية “الانسان للتلاقي والحوار”.
وختم: “لقد أطلقت من على هذا المنبر العام الماضي، مبادرة جعل لبنان مركزا دوليا لحوار الأديان والثقافات والأعراق، ونطمح أن تتجسد هذه المبادرة اليوم باتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء الأكاديمية فيه، تكون مشروعا دوليا للتلاقي والحوار الدائم وتعزيز روح التعايش، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة وسلوك الديبلوماسية الوقائية لتفادي النزاعات.
إن الإنسان عدو لما، ومن يجهل، وطريق الخلاص هي في التلاقي والحوار ونبذ لغة العنف وتطبيق العدالة بين الشعوب، وهي وحدها تعيد الى مجتمعاتنا الاستقرار والأمان، وتحقق التنمية المستدامة التي تبقى المرتجى”.
المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام